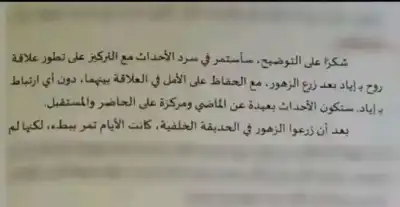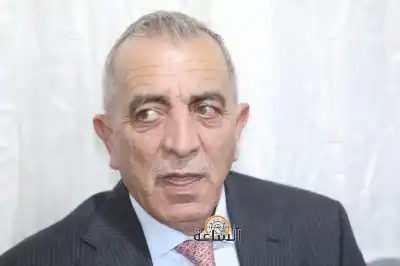مدار الساعة - مقال بقلم المدرب والمحاضر بالتمكين السياسي: فارس متروك شديفات - ليست الديمقراطية في العالم العربي، ولا سيما في الأردن، حُلماً طوباويًا، بل مشروعًا تراكميًا معقدًا، تتداخل فيه إرادات الدولة، وضغوط الداخل، ومطامح الخارج.
وفي خضم هذا المشهد، يأتي اصدار كتاب الدكتور أسامة تليلان "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الأردن (1989–2009)، ليقدّم أكثر من مجرد دراسة أكاديمية؛ إنه يشكّل وثيقة سياسية فكرية واستراتيجية، تحاول قراءة ما بين سطور التحول السياسي، وما فوق صوت الشعارات.
وفقًا لنظرية تحليل النظم التي اعتمدت لإجراء هذه الدراسة التحليلية: تَعتبر هذه النظرية الدولة نظامًا يحتوي على مدخلات (مطالب وضغوط المجتمع) وعمليات (معالجة سياسية وقانونية) ومخرجات (قرارات وتشريعات وسياسات)؛ وبذلك يُفهم المجتمع المدني ضمن هذا النموذج كعنصر فاعل يمد النظام السياسي بالمطالب والحقوق، ويراقب ويغذّي العملية الديمقراطية.
في هذا السياق فان مؤسسات المجتمع المدني تُعد جزءًا من مدخلات النظام السياسي، وتُسهم في تحقيق التوازن بين السلطة والمجتمع، حيث تُظهر الدراسة أن أثر المجتمع المدني يتأرجح بين أثر إلحاقي (رد فعل على التشريعات والسياسات) وأثر توازني (مبادرات ذاتية لتعزيز الديمقراطية).
لعل من المهم التوقف الواعي عند الاستنتاج الأبرز الذي يقدمه هذا العمل، وهو أن مؤسسات المجتمع المدني، رغم ازديادها الكمي وتنوعها الشكلي، ظلت في كثير من الأحيان رهينة للبيئة السياسية المقيدة، ما جعل أثرها أقرب إلى التفاعلات التجميلية منها إلى الأثر البنيوي.
وقد اشارت الاستنتاجات الرئيسية للدراسة (الكتاب) ان تطور المجتمع المدني في الأردن كان مرتبطًا عضوياً بمسار التحول الديمقراطي، إلا أن العلاقة لم تكن دائمًا إيجابية أو خطية؛ فقد شهدت مراحل من التراجع والقيود.
واستنتجت ايضاً ان القوانين المنظمة للعمل المدني والانتخابي لم تكن دائماً ديمقراطية الطابع، وأحيانًا كانت أداة للحد من فاعلية المجتمع المدني، مما قلّص من قدرته على التأثير الفعلي في عملية تعميق التحول الديمقراطي.
لقد أسهمت مؤسسات المجتمع المدني جزئيًا في تعزيز بعض مؤشرات الديمقراطية (مثل رفع الوعي السياسي أو الرقابة على الانتخابات)، لكن لم يكن لها الدور الحاسم في صوغ القوانين والسياسات أو تعديل الدستور.
وعلى الرغم من الزيادة العددية للمؤسسات المدنية، إلا أن الكثير منها افتقر إلى الاستقلالية، والفعالية، والبنية المؤسسية الديمقراطية، فالبيئة السياسية والتشريعية المقيدة، والتأطير الإداري لمؤسسات المجتمع المدني من قبل الدولة، شكلت عوامل حدّت من قدرته على التحول إلى قوة ضغط مؤثرة في السياسات العامة، فالتحول الديمقراطي بقي في كثير من الأحيان موجهًا من "أعلى" لا من "أسفل"، ما يجعل المجتمع المدني تابعًا للتحولات أكثر من كونه محفزًا لها.
ولعل من المناسب التنويه الى أهمية هذه الدراسة باعتبارها تمثل نموذجًا للدراسات التحليلية التي تستخدم أدوات كمية وكيفية لرصد وتحليل العلاقة بين مكونات النظام السياسي، وقد تميزت باستخدام منهج المقارنة الزمنية من (1989–2009) لتتبع التغيرات، وهو ما يعزز مصداقيتها وموضوعيتها.
ويمكن القول إنّ ما يضفي أهمية خاصة على هذا الكتاب، هو أنّ الدراسات المسحية تكشف عن قلّة البحوث في هذا المجال، ومن ثمّ جاء هذا الكتاب ليعالج الفراغ العلمي والفكري القائم.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال البعد الثقافي العميق الذي يشكّل الوعي السياسي في المجتمع الأردني، ويحدد إلى حد كبير ملامح تفاعل المجتمع المدني مع الدولة.
فالثقافة السياسية ليست مجرد خلفية، بل هي البيئة العقلية(الذهنية) التي تُزرع فيها بذور الديمقراطية أو تُخنق فيها، تاريخيًا، اتسمت الثقافة السياسية في الأردن بطابع أبوي سلطوي، قائم على الولاء والعلاقات الزبائنية، لا على الحقوق والمساءلة (المواطنة)، ومع الانفراج السياسي في أواخر الثمانينيات، والانفتاح الإعلامي والتحولات الإقليمية والدولية، بدأ هذا النمط بالتغير التدريجي، لكن دون أن يُنتج ثقافة ديمقراطية راسخة.
ومع تعاقب الأزمات الاقتصادية في الاردن، وصعود التيارات السياسية المختلفة، والتحولات الكبرى في المنطقة، فقد تزايد عدد مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن فاعليتها بقيت مرتبطة بقدرتها على التكيّف مع بيئة يغلب عليها الحذر والتوجس.
بعض هذه المؤسسات تبنّى نهج التكيّف التبعي، يعمل ضمن حدود ما تسمح به الدولة، ما يُسمى في الكتاب بـ "الأثر الإلحاقي"، وبعضها الآخر حاول التكيّف المراوغ بأن يناور أو يتجاوز، لكنه ظل محدود التأثير المجتمعي، والقلة القليلة فقط نجحت في تقديم نموذج مدني تحويلي، قادر على المبادرة والتأثير، حيث تبلورت مبادرات قاعدية قادرة على صياغة خطاب مدني نقدي، وخلق شبكات ضغط، خاصة في مجالات مثل حرية التعبير أو تمكين المرأة.
وهكذا، يظهر أن العلاقة بين الثقافة السياسية واستجابة المجتمع المدني ليست خطية، بل تفاعلية؛ فالثقافة هي التي تهيّئ الأرض، لكن المجتمع المدني هو من يزرع ويروي، فاذا كانت الأرض خصبة بالقيم الديمقراطية، فالزرع سينمو ويثمر، أما إذا ظلت مشبعة بالولاءات التقليدية والرهبة من الدولة، فإن أي عمل مدني سيكون هشًا، إما تابعًا أو مستأنسًا.
ولذلك، فإن التحول في الثقافة السياسية شرط سابق، أو متزامن لفاعلية المجتمع المدني، وتغذية هذه الثقافة يحتاج إلى سياسات متنورة تعليمية وإعلامية ومؤسساتية، تُكرّس قيم المواطنة (المشاركة، الشفافية، والمساءلة)
بلا شك ان الأهمية السياسية والفكرية للكتاب تتجاوز حدود الأردن؛ فهو يعكس المعضلة الكبرى في النظم السياسية الهجينة: كيف يمكن بناء ديمقراطية فعلية في ظل مؤسسات مجتمع مدني تُستأنس أكثر مما تُستقل؟ كيف يمكن للمجتمع المدني أن ينتقل من كونه أداة للتهذيب إلى قوة للمساءلة؟
في هذا السياق، يمكن النظر إلى الكتاب كمحرّك لتفكير جديد في بيئة العمل السياسي الأردني، حيث يُعاد الاعتبار للفاعلين في الفضاء العام، لا كمراقبين، بل كشركاء في تشكيل مستقبل التحول الديمقراطي.
وبناء على ذلك فلا يمكن أن تُزهر العدالة الاجتماعية، ولا أن تُثمر التنمية الحقيقية، إلا في تربة ديمقراطية تحتضن الجميع، فالديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل بيئة تُشرك المواطن في اتخاذ القرار، وتمنحه الشعور بأن صوته يصنع الفرق، ومن هنا، يصبح بناء مجتمع مدني حي وفاعل، ليس ترفًا، بل ضرورة، مجتمع بمؤسساته المتنوعة، يشكّل جسرًا بين الفرد والدولة، ويمنح المشاركة معناها الحقيقي.
فحين تنشأ مؤسسات المجتمع المدني على قواعد ديمقراطية، فإنها لا تكتفي بإدارة شؤون أعضائها، بل تزرع فيهم روح المسؤولية، وتُخرج من بينهم مواطنين واعين، قادرين على بلورة الرأي العام، ومساءلة السلطة بثقة، دون خوف، هذه المؤسسات تصبح مدارس للمواطنة، تنمّي الحس النقدي، وتكرّس ثقافة الشفافية والحوار.
وما بين الأحزاب والنقابات والجمعيات، تتوزع الأدوار، بعضها مباشر في التأثير على السياسات، وبعضها الآخر غير مباشر لكنه لا يقل أهمية؛ من خلال ممارسة ديمقراطية داخلية تعكس القيم التي تنشدها الدولة في فضائها العام، هكذا فقط، يصبح المجتمع المدني رافدًا حقيقيًا لديمقراطية صادقة، ومحرّكًا أصيلًا للتنمية السياسية المنشودة.
لذا، فإن التوصيات المستخلصة من الكتاب يجب أن تُقرَأ كأجندة عمل؛ فعلى السلطة التشريعية أن تعيد صياغة القوانين الناظمة للعمل المدني والإعلامي، لتكون متسقة مع روح الدستور لا فوقه.
وعلى الأحزاب والنقابات أن تعيد بناء بنيتها، على أسس الديمقراطية الداخلية والتمثيل العادل، وعلى الإعلام بتنويعاته أن يتحرّر من الخطاب الرسمي؛ وأن يفسح المجال للأصوات المهمّشة، وعلى الجامعات والمراكز البحثية أن تنقل المعرفة من رفوف المكتبات إلى ورش السياسات العامة.
وبالتالي فان على مؤسسات وهيئات النساء والشباب والعمال وذوي الإعاقة وكل المعنيين، أن يتحرّكوا من خانة المطالبة إلى موقع المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب يُعد مساهمة علمية نوعية، لفهم حدود وإمكانات المجتمع المدني في الأردن، كأحد أنظمة الإدخال الأساسية في النظام السياسي، ويطرح تساؤلات محورية حول مدى قدرة النظم السياسية في العالم العربي، على استيعاب وتفعيل قوى المجتمع المدني كمكون حيوي من مكونات التحول الديمقراطي الحقيقي.
والجدير بالذكر أن ما يميّز الكتاب هو قدرته على تحويل المعطى التاريخي إلى سؤال مستقبلي: ما العمل؟ وكيف نُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع؟ كيف نؤسس لشرعية تستند إلى آليات المواطنة والمشاركة لا إلى الولاء والغضب، وإلى الرقابة لا إلى التزكية؟
لقد آن الأوان لأن يُعاد تعريف مفهوم "التحول الديمقراطي" ليشمل ليس فقط الانتخابات أو التعددية، بل تمكين المجتمع المدني من القيام بوظيفته الأصلية: أن يكون قوة ضغط، وصوتًا للتعدد، وجسرًا بين المواطن والدولة.
إن كتاب تليلان، بهذا المعنى، ليس فقط إضافة معرفية إلى المكتبة الأردنية والعربية، بل هو لبنة في مشروع أوسع لإعادة بناء الفضاء العام، وفتح المجال العام أمام من يستحق أن يكون فيه، إنه نداء إلى كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين: لا تتركوا المجتمع المدني في منطقة الظل.
فإذا كنا حقًا نريد تحولاً ديمقراطيًا لا رجعة فيه، فعلينا أن نبدأ من حيث يبدأ الوعي: من سؤال المجتمع، من مساءلة الحكومات، ومن إعادة الاعتبار للمجتمع المدني بوصفه سياسيًا بالضرورة.